
أتتني هذه العبارة منذ زمن ،نقداً لاذعاً، ولعلها كانت محاولة ما لإيقافي عن اندفاع لا يهدأ. ..لعلها كانت غير ذاك ..المهم في الأمر أنّها بقيت ترنّ في داخلي تذكّرني أنّ الطاقة موردٌ يُستنزف وأن الحضور المستمر موت بطيء.
ولعلّني بالتدريج طوّرت قناعةً جديدة أن القضية ليست في إدارة الوقت كما نُردّد دائمًا، بل في إدارة الطاقة. فالوقت يمكن إن أن يُضغط ويُرتّب، أما الطاقة فهي رأس المال الحقيقي: إن نفدت، تبعثر كل شيء.
لكن عالم اليوم يجرّنا لمعادلة أخرى: التزامات اجتماعية ومهنية وأخرى تتعلق بإدارة صورتنا الرقمية بشكل مستمر . كأن الانشغال نفسه صار مرادفًا للقيمة، وكأن الصمت أو البطء صار ترفًا لا يليق بـ "الفاعلين”.
ليست هذه الثقافة وليدة الصدفة. فقد أشار اليها الفيلسوف الكوري بيونغ-تشول هان في كتابه "مجتمع الإرهاق" حيث أشار إلى ان المجتمعات الحديثة تحولت إلى ساحات يجلد فيها الأفراد أنفسهم تحت وهم الحرية والإنتاجية؛ لم يعد هناك من يُرغمهم من الخارج، بل هم من يستنزفون أنفسهم طوعًا. كما تكتب الباحثة الأمريكية شيري توركل في العزلة في زمن الاتصال قائلة ان التكنولوجيا منحتنا وهم الحضور الدائم، لكنها في العمق زادت من عزلتنا، وقوّضت قدرتنا على بناء علاقات أكثر إنسانية.
نعيش اليوم ما يُسمى بـ الإرهاق الرقمي، حيث تتحول أيامنا إلى سلسلة من مقاطعات متواصلة: إشعارات تقاطع لحظاتنا، ورسائل تختلس راحتنا ومنصات تتطلب حضورنا الدائم..وفي خلفية المشهد، يعمل ما يُعرف بـ اقتصاد الانتباه على تحويل وعينا إلى سلعة تُباع وتُشترى، تتنافس عليها الشركات الكبرى وتبيعها ..تبيعنا معها .
لكن الإتصال المستمر، او ما يطلق عليه اصطلاحا ب مفهوم connectivity رغم أنه منحنا متعة الشعور بتقريب المسافات ، سرق منا أشياء أعمق: قتل عزلة كنا نحتاجها لنسمع أنفسنا، وأضعف معنى الحضور الحقيقي في علاقاتنا، وحوّلنا إلى مؤدين دائمين في عرض لا ينطفئ.
ومع هذه التحولات، برزت ايضا ثقافة رأسمالية أشد وطأة: تُعطّم من الإنجازية السامة، تلك التي تقيس الإنسان بعدد الاجتماعات التي حضرها، بعدد المتابعين الذين جمعهم، بعدد الساعات التي عملها. وكأن النجاح معادلة حسابية باردة. …لكن هناك دوا أبعاد عصيّة على القياس: تجربة تُفتح كنافذة، لقاء صادق يُخفف وجعًا، أو كلمة صغيرة تُربّت على كتف من يحتاجها.
حتى في علاقاتنا الشخصية، تورّطنا هذه الثقافة. صرنا نعتقد أن الحب يُثبت نفسه بالوجود الدائم، وأن الاهتمام يُقاس بالرد السريع والحضور المستمر. لكن الحقيقة أن الحضور الدائم قد يُرهق العلاقة أكثر مما يُغذيها. فالمعنى لا يأتي من التكرار، بل من الصدق حين نختار أن نكون مع الآخر بكامل وعينا.
في عالمنا اليوم يتضاعف هذا الضغط. حيث الانشغال يُمجَّد كرمز للمكانة، والعمل المفرط يُقدَّم كدليل على الإخلاص، حتى لو كان على حساب الروح. ، ولكن الحقيقة أن مجتمعاتنا تخلط بين الصخب والقيمة، وبين الانشغال والجدوى…لكن الصلابة الحقيقية لا تكمن في الاستنزاف، بل في معرفة متى نتوقف، متى نبطئ، ومتى نعود إلى كهوفنا الداخلية لنُعيد شحن أرواحنا.
وهنا تأتي فلسفة الحياة البطيئة – slow living لتقدّم بديلاً لا كترف، بل كخيار وجودي. أن نختار الإيقاع الذي يناسبنا بدل الذي يُفرض علينا. أن نسمح لأنفسنا أن نغيب قليلًا كي نعود أكثر صدقًا. أن نُعيد تعريف الإنجاز: لا بما يظهر من أرقام، بل بما يتركه من أثر ومعنى.
قد لا يكون السرّ في أن نصمد أكثر، بل في أن نعرف متى نتوقف، متى نلتقط أنفاسنا، ومتى نترك للعالم ضجيجه بينما نصغي نحن لنبضنا الداخلي…فنحن في النهاية، لسنا مطالبين بأن نكون متاحين على الدوام، ولا أن نحمل العالم على أكتافنا. أحيانًا يكفي أن نبطئ، أن نترك الرسالة بلا رد، وأن نسمح ليوم يمرّ دون إنجازات كبرى. ربما هناك تبدأ الحياة الحقيقية: حين نتوقف عن الركض.
أتتني هذه العبارة منذ زمن ،نقداً لاذعاً، ولعلها كانت محاولة ما لإيقافي عن اندفاع لا يهدأ. ..لعلها كانت غير ذاك ..المهم في الأمر أنّها بقيت ترنّ في داخلي تذكّرني أنّ الطاقة موردٌ يُستنزف وأن الحضور المستمر موت بطيء.
ولعلّني بالتدريج طوّرت قناعةً جديدة أن القضية ليست في إدارة الوقت كما نُردّد دائمًا، بل في إدارة الطاقة. فالوقت يمكن إن أن يُضغط ويُرتّب، أما الطاقة فهي رأس المال الحقيقي: إن نفدت، تبعثر كل شيء.
لكن عالم اليوم يجرّنا لمعادلة أخرى: التزامات اجتماعية ومهنية وأخرى تتعلق بإدارة صورتنا الرقمية بشكل مستمر . كأن الانشغال نفسه صار مرادفًا للقيمة، وكأن الصمت أو البطء صار ترفًا لا يليق بـ "الفاعلين”.
ليست هذه الثقافة وليدة الصدفة. فقد أشار اليها الفيلسوف الكوري بيونغ-تشول هان في كتابه "مجتمع الإرهاق" حيث أشار إلى ان المجتمعات الحديثة تحولت إلى ساحات يجلد فيها الأفراد أنفسهم تحت وهم الحرية والإنتاجية؛ لم يعد هناك من يُرغمهم من الخارج، بل هم من يستنزفون أنفسهم طوعًا. كما تكتب الباحثة الأمريكية شيري توركل في العزلة في زمن الاتصال قائلة ان التكنولوجيا منحتنا وهم الحضور الدائم، لكنها في العمق زادت من عزلتنا، وقوّضت قدرتنا على بناء علاقات أكثر إنسانية.
نعيش اليوم ما يُسمى بـ الإرهاق الرقمي، حيث تتحول أيامنا إلى سلسلة من مقاطعات متواصلة: إشعارات تقاطع لحظاتنا، ورسائل تختلس راحتنا ومنصات تتطلب حضورنا الدائم..وفي خلفية المشهد، يعمل ما يُعرف بـ اقتصاد الانتباه على تحويل وعينا إلى سلعة تُباع وتُشترى، تتنافس عليها الشركات الكبرى وتبيعها ..تبيعنا معها .
لكن الإتصال المستمر، او ما يطلق عليه اصطلاحا ب مفهوم connectivity رغم أنه منحنا متعة الشعور بتقريب المسافات ، سرق منا أشياء أعمق: قتل عزلة كنا نحتاجها لنسمع أنفسنا، وأضعف معنى الحضور الحقيقي في علاقاتنا، وحوّلنا إلى مؤدين دائمين في عرض لا ينطفئ.
ومع هذه التحولات، برزت ايضا ثقافة رأسمالية أشد وطأة: تُعطّم من الإنجازية السامة، تلك التي تقيس الإنسان بعدد الاجتماعات التي حضرها، بعدد المتابعين الذين جمعهم، بعدد الساعات التي عملها. وكأن النجاح معادلة حسابية باردة. …لكن هناك دوا أبعاد عصيّة على القياس: تجربة تُفتح كنافذة، لقاء صادق يُخفف وجعًا، أو كلمة صغيرة تُربّت على كتف من يحتاجها.
حتى في علاقاتنا الشخصية، تورّطنا هذه الثقافة. صرنا نعتقد أن الحب يُثبت نفسه بالوجود الدائم، وأن الاهتمام يُقاس بالرد السريع والحضور المستمر. لكن الحقيقة أن الحضور الدائم قد يُرهق العلاقة أكثر مما يُغذيها. فالمعنى لا يأتي من التكرار، بل من الصدق حين نختار أن نكون مع الآخر بكامل وعينا.
في عالمنا اليوم يتضاعف هذا الضغط. حيث الانشغال يُمجَّد كرمز للمكانة، والعمل المفرط يُقدَّم كدليل على الإخلاص، حتى لو كان على حساب الروح. ، ولكن الحقيقة أن مجتمعاتنا تخلط بين الصخب والقيمة، وبين الانشغال والجدوى…لكن الصلابة الحقيقية لا تكمن في الاستنزاف، بل في معرفة متى نتوقف، متى نبطئ، ومتى نعود إلى كهوفنا الداخلية لنُعيد شحن أرواحنا.
وهنا تأتي فلسفة الحياة البطيئة – slow living لتقدّم بديلاً لا كترف، بل كخيار وجودي. أن نختار الإيقاع الذي يناسبنا بدل الذي يُفرض علينا. أن نسمح لأنفسنا أن نغيب قليلًا كي نعود أكثر صدقًا. أن نُعيد تعريف الإنجاز: لا بما يظهر من أرقام، بل بما يتركه من أثر ومعنى.
قد لا يكون السرّ في أن نصمد أكثر، بل في أن نعرف متى نتوقف، متى نلتقط أنفاسنا، ومتى نترك للعالم ضجيجه بينما نصغي نحن لنبضنا الداخلي…فنحن في النهاية، لسنا مطالبين بأن نكون متاحين على الدوام، ولا أن نحمل العالم على أكتافنا. أحيانًا يكفي أن نبطئ، أن نترك الرسالة بلا رد، وأن نسمح ليوم يمرّ دون إنجازات كبرى. ربما هناك تبدأ الحياة الحقيقية: حين نتوقف عن الركض.
-
 قضايا أردنية كُبرى برسم النقاش العام2025-12-01
قضايا أردنية كُبرى برسم النقاش العام2025-12-01 -

-
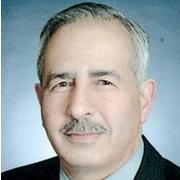 اتجاهات حديثة في التدريس والتطوير التربوي2025-11-30
اتجاهات حديثة في التدريس والتطوير التربوي2025-11-30 -
 ماذا تريد دولة الاحتلال من سوريا؟2025-11-30
ماذا تريد دولة الاحتلال من سوريا؟2025-11-30 -
 جرائم المستعمرة تستهدف الهيمنة والتسلط2025-11-29
جرائم المستعمرة تستهدف الهيمنة والتسلط2025-11-29



